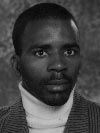
ثالثاً: كما أنّ الخوارج كفّروا من عداهم من المسلمين، وقالوا إنّ مرتكب الكبيرة كافر مخلّد في النار، واستحلّوا دماءهم وأموالهم، وسبي ذراريهم، وقالوا إنّ دار الإسلام تصير بظهور الكبائر فيها دار كفر حتّى أنّهم قتلوا عبد الله بن خباب أحد أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) صائماً في شهر رمضان والقرآن في عنقه وقتلوا زوجته وهي حبلى وبقروا بطنها ; لأنّه لم يتبرّأ من علي بن أبي طالب، وقالوا له هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك فذبحوه على شاطئ النهر حتّى سال دمه في النهر. وكانوا إذا أسروا نساء المسلمين يبيعونهن فيما بينهم حتّى أنهم تزايدوا في بعض الوقائع على امرأة جميلة وغالوا في ثمنها فقام بعضهم فقتلها وقال إن هذه الكافرة كادت تقع فتنة بسببها بين المسلمين، وقالوا للحسن بن علي يوم ساباط المدائن: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك.
كذلك الوهّابييون حكموا بشرك من خالف معتقدهم من المسلمين، واستحلّوا ماله ودمه، وبعضهم استحلّ سبي الذرّية، ولم يخاطبوه إلاّ بقولهم يا مشرك، وجعلوا دار الإسلام دار حرب، ودارهم دار إيمان تجب الهجرة إليها، وحكموا بقتال تارك الفرض، وإن لم يكن مستحلاً(1).
وبلغت بهم الجرأة في تكفير المسلمين بحيث يبيحون نهب أموال المسلم، وسفك دمائهم بسهولة، وقد فعلوا ذلك في تاريخهم مراراً.
رابعاً: كما أنّ الخوارج سيماهم التحليق أو التسبيد كذلك الوهّابيون سيماهم التحليق.
وفي حديث عن الخوارج: التسبيد فيهم فاش، وهو الحلق واستئصال الشعر.
روي أنّه قيل لأبي سعيد الخدري: هل سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يذكر الخوارج فقال: سمعته يذكر قوماً يتفقّهون في الدين، يحقّر أحدكم صلاته عند صلاته، وصومه
____________
1- كشف الارتياب في أتباع محمّد بن عبد الوهّاب: ١١٤.
عند صومه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية... إلى أنّ يقول قيل: يا رسول الله ألهم آية أو علامة يعرفون بها؟ فقال: نعم، التسبيد فيهم فاش(1).
وقال أحمد زيني دحلان: عن السيّد عبد الرحمن الأهدل مفتي زبيد يقول: لا حاجة إلى التأليف في الردّ على الوهّابية بل يكفي في الردّ عليهم قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) سيماهم التحليق، فإنّه لم يفعله أحد من المبتدعة غيرهم(2).
خامساً: كما أنّ الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) عنهم بما رواه البخاري: «قوم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد»(3).
كذلك الوهّابييون يقتلون أهل الإسلام وحدهم، ولم ينقل عنهم أنّهم حاربوا أحداً سوى المسلمين، هل وجدت ثمة دعوة إلى الجهاد أو غزى الوهّابية اليهود والصهاينة الذين احتلّوا بلاد المسلمين واستعمروها.
فقد قتلوا جملة من المسلمين من أهل الحجاز والطائف والبلدان المجاورة بلا ذنب، وغزوهم بلاد الإسلام المجاورة لهم كالعراق واليمن وشرقي الأردن وغيرهم، وقتلهم أهل كربلاء سنة ١٢١٦هـ ، وقتلهم من ظفروا به من المسلمين، وعدم غزوهم للمستعمرين أو الصهيونيّين وتوجيه بأسهم وحربهم كله إلى المسلمين والعرب أقوى شاهد على ذلك(4).
هاك العراق فهو خير شاهد على ما نقوله، تصلنا أنباء عمّا أرتكبه هؤلاء القوم من أعمال قاسية ووحشيّة، ذهب ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من
____________
1- الفائق في غريب الحديث ٣: ٢٣٤.
2- فتنة الوهّابية ١٩.
3- صحيح البخاري ٤: ١٠٨، صحيح مسلم ٣: ١١٠.
4- لمزيد راجع عنوان المجد في تاريخ نجد في جزئين.
النساء والشيوخ والصبيان، خلال مجازر وحشيّة، وانفجارات للسيارات المفخّخة في وسط الأسواق والأزقّة قلّ أن شهد لها التاريخ نظيراً، سوى أنّهم يتبعون أهل البيت(عليهم السلام)، بحجّة مقاومة الاحتلال ولكنّهم لم يقتلوا من القوات المحتلة إلاّ النادر على سبيل الصدفة، وكلّ ذلك يتحقّق بفتوى كبار علماء الوهّابية، وسيدفع هؤلاء المجرمون الثمن غالياً لفعلتهم الشنعاء هذه، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ﴾(1).
فهذه مجمل نقاط الالتقاء بينهم وبين الخوارج، وهناك أوجه شبه أخرى لم نذكرها روماً للاختصار(2).
نقطة التحوّل:
يقول «محمّد حبيب»: «إنّ الوهّابية سجنوني ثلاثة أشهر كنت أنتقل خلالها من زنزانة إلى زنزانة أخرى، وقد اتعبوني كثيراً، وهناك لمست حقيقة الوهّابية الغليظة والمتحجّرة، وقرأت كتبهم، واستمعت إلى أحاديثهم، وعرفت انطباعاتهم، فقارنت كلّ ذلك مع ما يحمله فكر أهل البيت(عليهم السلام)، ومع نهج أتباعهم، وعطائهم العلمي والإنساني الجهادي، فوجدت الفرق الشاسع، والبون بين المسلكين، وعندها اتّخذت القرار الحاسم، وهو اعتناق مذهب الحقّ، ونبذ الوهّابية، وذكرياتهم المرّة، وعندما غادرت السجن بعدها رجعت إلى بلادي غينيا، وفور وصولي أعلنت تشيّعي على رؤوس الإشهاد، وطلبت الماء، وتوضأت أمام الوهّابيين، ومسحت على رجلي، فاغتاظوا منّي، وهكذا منّ الله تعالى عليّ بالنجاة من الهلكة، وعرّفني سبيل الهداية، ﴿وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء مِن دُونِهِ﴾(3)
____________
1- الشعراء -٢٦- : ٢٢٧.
2- للمزيد راجع كشف الارتياب في أتباع محمّد بن عبد الوهّاب: ١٠٩ - ١١٠.
3- الإسراء -١٧- : ٩٧.
(٧٨) محمّد رمضان جالوا (مالكي / غينيا - كوناكري)
ولد عام ١٤٠٥هـ (١٩٨٥م) بمدينة (بتمى) في غينيا في أسرة مالكيّة تتبع النهج الأشعري في العقيدة، حيث دخل في سلك طلب العلوم الدينيّة، ودرس فيها مدّة عشر سنوات، إلاّ أنّه تعرّف على مذهب أهل البيت(عليهم السلام) عن طريق والده، ثمّ وبعد صراع طويل مع نفسه اعتنق مذهب الشيعة الإماميّة في الشام (في منطقة السيّدة زينب(عليها السلام) وذلك عام ٢٠٠٣م.
تعرّفه على الشيعة:
يقول محمّد رمضان: «إنّ من أسباب تعرّفي على مذهب أهل البيت(عليهم السلام) هو أنّ والدي الشيخ محمّد بيلو جالوا سافر إلى دمشق بقصد دراسة المذهب الشيعي، ودرس في إحدى الحوزات العلميّة هناك، واعتنقه عن إرادة وقناعة تامّة بأنّه هو المذهب الخالي من الشوائب والملابسات، وعندما عاد إلى غينيا في زيارة قصيرة تحدّث إليّ وإلى عائلتي عن مذهب أهل البيت(عليهم السلام)، وتكرّرت جلساتي معه، ولكنّ قلبي ما كان ليقتنع ويميل إلى كلامه، فقد كنت أتتلمذ على يد الشيخ جرن محمّد عمر ابن جرن من علماء المالكيّة في منطقتنا منذ عشرة أعوام، وكان يحيطني بمحبّة ورعاية خلال تلك السنين».
المنازعة مع النفس:
يقول «محمّد رمضان»: «كنت أفكّر في كلام والدي كيف يسرد لنا أدّلة حول أحقّية أهل البيت(عليهم السلام) في الخلافة، ونهجهم في كيفيّة الوضوء والصلاة حيث كانت صلاتهم ووضوئهم مطابقاً لوضوء رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) حيث يقول كما في حديث مالك ابن الحويرث: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»(1)، والروايات الواردة في حقّهم من حديث الثقلين والغدير والسفينة وغيرها».
ويضيف قائلاً: «وشاءت الأقدار أن افترقت عن أستاذي لأعود إلى العاصمة، ولمّا عدت للمنزل وصلتني رسالة من أستاذي يطلب منّي عدم تغيير مذهبي، ويلحّ بالطلب، وهذا ما زاد استغرابي، ومن جانب آخر كان أبي يحاول أقناعي بشتّى الوسائل لركوب سفينة النجاة، وقد أخذتني الحيرة بين أن أتّبع أستاذي وبين أن أستمع وأقرّ باستدلالات والدي؟
وعاد والدي إلى سوريا، وبعد مضيّ أشهر أرسل إليّ رسالة يطلب منّي الحضور لسوريا لأدرس معه في الحوزة، فرفضت ذلك، وكرّر طلبه، وألحّ عليّ، فقلت في نفسي: أسافر إلى سوريا (دمشق) لعلّني أتمكّن من أنّ أكمل دراستي في المذهب المالكي، وإذا لم أتمكّن من ذلك أعود إلى بلدي غينيا.
وبالفعل توجّهت إلى دمشق حاملاً أحلاماً ورؤى عن متابعة دراسة مذهبي، ولمّا وصلت، التقيت بوالدي، وطلبت منه أن يعرّفني على الأماكن والمعاهد التي تقوم بتدريس المذهب المالكي في دمشق، فطلب منّي أن أريح نفسي بعض الوقت، ومن ثمّ يساعدني، فوافقت، وأقمت معه في البيت الذي أستأجره، وكان يزوره العديد من المشايخ والسادة من الشيعة الإماميّة، ويتباحثون في مسائل وجدت أنّي في
____________
1- السنن الكبرى ٢: ٣٤٥.
البداية أعرفها كمواد تاريخيّة، ولكنّ معرفتي كانت ظاهريّة، وليست معمّقة، كما هم يتحدّثون فيها، وفكّرت أن أعود لبلدي غينيا، ولكنّ والدي ألحّ عليّ أن أبحث عن الحقّ جيّداً، وأترك التعصّب جانباً، وهذه هي الفرصة المناسبة لمعرفة الحقيقة، واستغلّ وجودي في دمشق حيث المكتبات التاريخيّة الكبيرة التي ربمّا لا تحصل عليها في بلدنا.
وبالفعل صرت أتوجّه وأشارك بالحديث مع أصدقاء والدي شيئاً فشيئاً، وكانوا يصرّون عليّ أن أتأكّد من حقيقة كلامهم بالعودة للمصادر السنّية المختلفة، وأخذت أقارن الأحاديث باستدلالات الشيعة، فرأيت استدلالهم قويّ وحجّتهم دامغة، وحتّى أنّي حضرت مناظرة جرت بين أحد السادة وأحد المشايخ السنّة، وكنت أرى السنّي يلتزم كثيراً من الصمت في الموارد الهامّة والمصيريّة مثل مسألة السقيفة، ومسألة الهجوم على بيت السيّدة الزهراء(عليها السلام)، وأرى الشيعي يصول ويجول، ويقدّم الدليل تلو الدليل، وكيف يتناول المسائل الخلافيّة بين الشيعة والسنّة من قبيل اعتقاد الشيعة بعدالة الله من أنّه عادل غير ظالم، بمعنى أنّه يقوم بالقسط، وأنّه لا يجور، ولا يظلم، فلا يجوز في قضائه، ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين، وله أن يجازي العاصين، ولا يكلّف عباده ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقّونه».
الله عادل لا يجور:
إنّ مفهوم العدل في اللغة بمعنى ما قام في النفوس أنّه مستقيم، وهو ضدّ الجور والحكم بالحق، أو السويّة والاستقامة، أو المرضي من الناس قوله وحكمه(1).
____________
1- لاحظ العين ٢: ٣٨، القاموس المحيط ٤: ١٣، لسان العرب ١١: ٤٣٠، تاج العروس ١٥: ٤٧١ - ٤٧٣.
وفي العرف العام استعمل بمعنى رعاية حقوق الآخرين، إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ولكن أحياناً هكذا يعرف بأنّ العدل: وضع الشيء في موضعه وعلى وفق هذا التعريف، يكون العدل مرادفاً للحكمة، والفعل العادل مساوياً للفعل الحكيم(1).
إذن فيمكن أن يتصوّر للعدل المعاني التالية:
الحكم بالحق والسويّة وهو ضدّ الجور، أو رعاية حقوق الآخرين، أو إصدار الفعل على وجه الحكمة.
وعلى ضوء ذلك، فلا يلازم العدل، القول بالتسوية بين البشر جميعاً، أو بين الأشياء كلّها، وكذلك فإنّ مقتضى الحكمة والعدل الإلهي لا يعني خلق المخلوقات بصورة متساوية فيخلق - مثلاً - للإنسان القرون، أو الأجنحة أو غيرها بل إن مقتضى حكمة الخالق وعدله أن يخلق العالم الإلهي أن يكلّف كلّ إنسان بمقدار استعداده وقابلّيته، وأن يقضي ويحكم فيه على حسب قدرته وجهده الاختياري، وأن يجازيه ثواباً أو عقاباً بما يتلاءم مع أفعاله(2).
وأمّا بالنسبة لله تعالى فإنّ العدل من أبرز مصاديق صفاته الثبوتيّة الكماليّة من أنّه عادل غير ظالم، بمعنى أنّه يقوم بالقسط، وأنّه لا يجور، ولا يظلم، فلا يجور في قضائه، ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين، وله أن يجازي العاصين، ولا يكلّف عباده ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقّونه.
وقد أستدلّ على عدله بالكتاب والسنّة والعقل:
قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ﴾(3)
____________
1- نظرة حول دروس في العقيدة الإسلاميّة: ٩٢.
2- نظرة حول دروس في العقيدة الإسلاميّة: ٩٢.
3- آل عمران -٣- : ١٨.
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة﴾(1).
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾(2).
قال تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾(3).
مضافاً إلى حكم العقل، حيث يحكم بوضوح بالعدل الإلهي ; لأنّ العدل صفة كمال، والظلم صفة نقص، والعقل يحكم بأنّ الله تعالى مستجمع لجميع صفات الكمال، منزّه عن كلّ عيب ونقص في مقام الذات وفي مقام الفعل.
فلو كان يفعل الظلم والقبح - تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً - فإنّ الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور:
١) إمّا أن يكون جاهلا بالأمر، فلا يدري أنّه قبيح.
٢) وإمّا أن يكون عالماً به، ولكنّه مجبور على فعله وعاجز عن تركه.
٣) وإمّا أن يكون عالماً به، وغير مجبور عليه، ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون فعله له تشهياً وعبثاً ولهواً، فهو لا يبالي بإتيان الأفعال الظالمة رغم علمه بقبحها، ورغم قدرته على القيام بالعدل(4).
ومن البديهي أنّه لا سبيل لأيّ واحد من هذه الصور إلى الذات الإلهيّة المقدّسة، وكلّ هذه الصور محال على الله تعالى، وتستلزم النقص فيه، وهو محض الكمال ; فيجب أن نحكم أنّه منزّه عن الظلم، وكلّ ما هو قبيح، ومنزّه عن الجهل، والعجز، وعن الاحتياج والسفه ; ولهذا فإن جميع أفعاله تتّسم بالعدل والحكمة.
____________
1- النساء -٤- : ٤٠.
2- يونس -١٠- : ٤٤.
3- غافر -٤٠- : ٣١.
4- عقائد الإماميّة: ٤٠.
غير أنّ بعض المسلمين جوّز عليه تعالى فعل القبيح، تقدّست أسماءه، فجوّز أن يعاقب المطيعين، ويدخل الجنّة العاصين بل الكافرين، وجوّز أن يكلّف العباد فوق طاقتهم، وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك يعاقبهم على تركه، وجوّز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض، ولا مصلحة، متمسّكين بقوله تعالى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾(1).
ومرجع الخلاف بين العدليّة وغيرهم في نقطة مركزية ومحوريّة أساسيّة، وهي قبول مسألة الحُسن والقبح العقليّين وإنكارها، فإنّ الشيعة والمعتزلة في رأيهم حول موضوع العدل الإلهي يطلق عليهما بمصطلح الكلامي (العدليّة) مقابل الأشاعرة، ولأجل أهميّة هذا الموضوع، اعتبر من المواضيع الرئيسيّة في علم الكلام، وممّيزات المذهب الكلامي للشيعة والمعتزلة.
فقد أنكر الأشاعرة الحُسن والقبح العقليّين، واعتقدوا بأنّ الحُسن في الأمور التكوينيّة هو ما يفعله الله، وأمّا في الأمور التشريعيّة فالحُسن ما يأمر به الله، وليس الفعل في ذاته حسناً ; ولأجل ذلك يفعله الله، أو يأمر به بخلاف العدليّة، فيعتقدون بأنّ الأفعال تتّصف في ذاتها بالحُسن والقبح بغضّ النظر عن انتسابها التكويني والتشريعي لله تعالى، ويمكن للعقل - إلى حدّ ما - أن يدرك جهات الحُسن والقبح في الأفعال.
قال المحقّق نصير الدين الطوسي قدّس سرّه في شرح قواعد العقائد: «الأفعال تنقسم إلى حسن وقبيح، وللحُسن والقبح معان مختلفة:
فمنها: أن يوصف الفعل الملايم أو الشيء الكامل بالحُسن والناقص بالقبح.
وليس المراد هنا هذين المعنيين، بل المراد بالحُسن في الأفعال ما لا يستحقّ
____________
1- الأنبياء -٢١- : ٢٣.
فاعله بسببه ذمّاً أو عقاباً، وبالقبح ما يستحّقها بسببه.
وعند أهل السنّة: ليس شيء من الأفعال عند العقل بحسن ولا بقبيح، وإنّما يكون حسناً أو قبيحاً بحكم الشرع فقط.
وعند المعتزلة: أنّ بديهة العقل تحكم بحُسن بعض الأفعال، كالصدق النافع، والعدل، وقبح بعضها كالظلم، والكذب الضارّ، والشرع أيضاً يحكم بهما في بعض الأفعال، والحسن العقلي ما لا يستحقّ فاعل الفعل الموصوف به الذمّ، والقبيح العقلي ما يستحقّ به الذمّ، والحسن الشرعي ما لا يستحقّ به العقاب، والقبيح ما يستحقّ به، وبإزاء القبح الوجوب، وهو ما يستحقّ تارك الفعل الموصوف به الذمّ والعقاب.
ويقولون: إنّ الله تعالى لا يُخلّ بالواجب العقلي، ولا يفعل القبيح العقلي البتّة، وإنّما يُخلّ بالواجب ويرتكب القبيح بالاختيار، جاهل أو محتاج.
واحتجّ عليهم أهل السنّة: بأنّ الفعل القبيح كالكذب مثلاً، قد يزول قبحه عند اشتماله على مصلحة كلّية عامّة، والأحكام البديهيّة ككون الكلّ أعظم من الجزء، لا يمكن أن يزول بسبب أصلاً»(1).
فمحلّ النزاع في الحُسن والقبح العقليّين بين العدليّة والأشاعرة وغيرهم من أهل الخلاف هو حكم العقل باستحقاق فاعل العدل للمدح، وباستحقاق فاعل الظلم للذميّ، فالعدليّة والمعتزلة أثبتوه، بخلاف الأشاعرة، وأمّا حُسن الملائم وقبح المنافر، أو حُسن الكامل وقبح الناقص، من معاني الحُسن والقبح، فلا خلاف فيه، بل كلّهم اتّفقوا على حكم العقل بهما.
وأمّا الإماميّة والمعتزلة فقد ذهبتا إلى أنّ حكم العقل في ذلك بديهيّ في بعض الأفعال كحُسن الصدق النافع، والإحسان والعدل، وقبح الكذب الضارّ والإساءة
____________
1- كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد: ٢٤٥.
والظلم، ونظري في بعض آخر كقبح الصدق الضار، أو حسن الكذب النافع، كما أنّه لا حكم له في قسم ثالث من الأفعال كالعبادات والمخترعات الشرعيّة، بل يحتاج في تشخيص حسنها أو قبحها إلى الشرع الكاشف عنهما، فدعوى الحُسن والقبح والعقليّين بلا واسطة الشرع في بعض الأفعال لا جميعها(1).
فالنتيجة في ذلك كلّه: من أنّ الله عزّ وجلّ عادل كريم، خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وعمّهم بهدايته، بدأهم بالنعم، وتفضّل عليهم بالإحسان، لم يكلّف أحداً إلاّ دون الطاقة، ولم يأمره إلاّ بما جعل له عليه الاستطاعة، لا عبث في صنعه، ولا تفاوت في خلقه، لا قبيح في فعله، جلّ عن مشاركة عباده في الأفعال، وتعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال، لا يعذّب أحداً إلاّ على ذنب فعله، ولا يلوم عبداً إلاّ على قبيح صنعه، لا يظلم مثقال ذرّة ; فإنّ تكُ حسنة يضاعفها، ويؤت من لدنه أجراً عظيماً.
وعلى هذا القول جمهور أهل الإماميّة، وبه تواترت الآثار عن آل محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم)، وإليه يذهب المعتزلة بأسرها إلاّ ضراراً منها وأتباعه، وهو قول كثير من المرجئة، وجماعة من الزيديّة والمحكّمة، ونفر من أصحاب الحديث، وخالف فيه جمهور العامّة، وبقايا ممّن عددناه، وزعموا أنّ الله تعالى خلق أكثر خلقه لمعصيته، وخصّ بعض عباده بعبادته، ولم يعمّهم بنعمته، وكلّف أكثرهم ما لا يطيقون من طاعته، وخلق أفعال جميع بريّته، وعذّب العصاة على ما فعله فيهم من معصيته، وأمر بما لم يرد، ونهى عمّا أراد، وقضى بظلم العباد، وأحبّ الفساد، وكره من أكثر عباده الرشاد. تعالى عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً(2).
____________
1- بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإماميّة ١: ١٠٧.
2- أوائل المقالات: ٥٨.
اتّباع سبيل الحقّ:
ويقول «محمّد رمضان»: أنّه في أحد الأيّام حضرت أحد الدروس التي كان والدي يتلقّاها في الحوزة العلميّة، فازادت دهشتي وأعجابي بما يطرح من دروس، فهذه الدروس تختلف تماماً عمّا ألفناه من مشايخنا أتباع المذهب السنّي، كان هناك المنطق هو السائد، والاستدلال بالعقل والنقل، وليس كما يفعل أهل السنّة من أخذ الحديث الغث والسمين، الصحيح أو الضعيف يعتبرونه حجّة، ورأيت أنّ صحيح البخاري ليس هو إلاّ كتاب جمع بين دفّتيه ما أمره سلاطين الظلم من وضعه، وإخفاء الكثير من فضائل العترة الطاهرة(عليهم السلام)».
يقول أيضاً: «إنّ من أسباب استبصاري والتزامي بمنهج الحقّ هو والدي حيث مهّد لي الطريق للوصول إلى الحقّ، وبعد بحث طويل وشاق اهتديت إلى مذهب محمّد وآل محمّد، وأعلنت استبصاري في منطقة السيّدة زينب(عليها السلام)، واتّبعت أوامر النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) بالتمسكّ بالثقلين كتاب الله وعترته أهل بيته، فالحمد لله الذي جمعنا على الولاء لأهل بيت النبوّة الأطهار(عليهم السلام)، والتبرّي من أعدائهم».
(٧٩) محمّد علي جلّو (مالكي / غينيا - كوناكري)
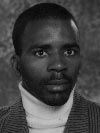
مرّت ترجمته في ١: ٤٦٧ من هذه الموسوعة، ونشير هنا إلى سائر ما حصلنا عليه من معلومات لم تذكر من قبل.
إحدى الأمور التي توصّل إليها «محمّد» بعد قرائته للمصادر الحديثيّة والتاريخيّة عند أهل السنّة هو وهن الاعتقاد بعدالة كلّ الصحابة، وهو ما يدّعيه من يسمّون أنفسهم بأتباع الصحابة، حيث شاهد نماذج كثيرة من الأخبار التي تذكر عدم التزام بعض الصحابة بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة.
نظريّة عدالة الصحابة:
قد يتسائل البعض حول سبب إصرار الشيعة على التطرّق الدقيق لأفعال الصحابة ومعتقداتهم واستقراءها استقراءً تامّاً من مصادر التاريخ.
ما ينبغي أن يقال في هذا المجال هو أنّ الحرص على أصالة الدين وعدم انحرافه والتحقيق فيمن يأخذ المسلمون دينهم منهم يحتّم إيلاء هذه الحقيقة الاهتمام البالغ والبحث المستفيض، وذلك لكشف حقيقة الصحابة والتابعين ولكي تنجلي الغبرة ويتّضح من كان منهم عادلاً مستقيماً في دينه وكلامه ليؤخذ به، ومن علم فسقه
أو أسقطه النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)من خلال التحذير منه أو من خلال لعنه ومن بدرت منه دلائل النفاق ليترك ولا يتّبع في معتقد وعمل.
إلاّ أنّ الصعب في هذا المجال هو جمع القرائن والآثار لكي يصل الباحث إلى النتيجة المطلوبة، لاسيّما بعدما علمناه من إحراق السنّة وتعطيل رواياتها لعقود طويلة ممّا أتاح فرصة الدسّ والتزوير لمن يحاول جاهداً تجاهل تلك الدلائل والقرائن وإثبات فكرة عدالة جميع الصحابة.
ولا يخفى أنّ فكرة كون الصحابة من العدول تشكّل الأرضية المناسبة لكلّ تحريف في الدين، وذلك بالثقة التي تمنحها لمن ليس أهلاً لها، فيوضع الصحابي فوق المساءلة ويُسدّ بذلك الباب أمام الباحثين، دون الاجتهاد في التمييز بين الغثّ والسمين فيما يصدر ويروى عنهم.
بين طلحة وعائشة:
إحدى الوقائع التاريخيّة التي تصرّف فيها بعض مصنّفي أهل السنّة ساعين بذلك إبعاد الصحابة عن موضع التهمة وإيذاء النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) هي مورد نزول الآية الكريمة: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيًما﴾(1).
فقد ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ الآية، أنّه قال: نزلت في طلحة بن عبيد الله لأنّه قال: إذا توفّي رسول الله تزوّجت عائشة(2).
إلاّ أنّ بعض المصادر تجنّبت عن ذكر اسم «طلحة» لكي لا تُنال مكانته
____________
1- الأحزاب -٣٣- : ٥٣.
2- الطبقات الكبرى ٧: ٢٠١، وذكر نحوه السيوطي في الدّر المنثور ٥: ٢١٤.
السامية عند أهل السنّة وهم الذين حدّثوا أنّه أحد العشرة المبشّرين بالجنّة(1)ورووا في فضله روايات عديدة، فاكتفت هذه المصادر بقول: قال رجل من أصحاب النبيّ(2)، الحديث.
كما سعى بعض آخر ممّن ألّف في تراجم الصحابة إلى ذكر شخص آخر بنفس الاسم وقالوا إنّ هذا الآخر أيضاً سُمّي بطلحة الخير، ولم ينقلوا عنه أيّ واقعة إلاّ أنّهم قالوا: أنّه صحابي أيضاً، وقيل أن الذي نزلت فيه الآية هو طلحة هذا(3).
إلاّ أنّ هذا القول يعارض المصادر التي ذكرت أطراف القصّة وأوصاف بطلها والتي تُثبت أنّ هذا الشخص هو طلحة المعروف، حيث نقل عن ابن عبّاس أنّه قال: «قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) على حرام نفسه: لو توفّي رسول الله لتزوّجت عائشة وهي بنت عمّي»(4).
وذكر الواحدي النيسابوري هذه الواقعة فقال: «قال ابن عبّاس في رواية عطاء: قال رجل من سادة قريش: لو توفّي رسول الله لتزوّجت عائشة، فأنزل الله تعالى ما أنزل»(5).
فمن هو طلحة هذا المتّصف بأنّه من سادة قريش وكبرائها وأنّه من العشرة الذين كانوا مع النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) غير طلحة صاحب الزبير؟!
وقد قال ابن كثير في تفسيره(6) بعد ذكر الرواية: «قال مقاتل بن حيان وعبد
____________
1- سنن أبي داود ٢: ٤٠١، سنن الترمذي ٥: ٣١٢.
2- راجع: السنن الكبرى ٧: ٦٩، زاد المسير لابن الجوزي ٦: ٢١٣، تفسير القرطبي ١٤: ٢٢٨ وتفسير الثعلبي ٨: ٦٠.
3- راجع: اسد الغابة ٣: ٦٢، الإصابة ٣: ٤٣٣.
4- تفسير القرطبي ١٤: ٢٢٨، وذكر نحوه المقريزي في إمتاع الأسماع ١٠: ٢٥٧.
5- أسباب نزول الآيات: ٢٤٣.
6- تفسير ابن كثير ٣: ٥١٣.
الرحمن بن زيد بن أسلم، وذكر بسنده عن السدي: إنّ الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتّى نزل التنبيه على تحريم ذلك»(1).
ويؤيّد ذلك ما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة حيث ذكر أنّ عمر بن الخطّاب بعد طعنه من قبل أبي لؤلؤة جمع ستّة من كبار الصحابة ومن بينهم طلحة، ثمّ أقبل عليهم واحداً واحداً يذكّرهم بخصالهم التي لم تلق له، إلى أن أقبل على طلحة، فقال له: أقول أم أسكت؟ قال: قل، فإنّك لا تقول من الخير شيئاً، قال: أمّا إني أعرفك منذ أصيبت إصبعك يوم أحد وائياً(2) بالذي حدث لك، ولقد مات رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ساخطاً عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب.
ثمّ يقول ابن أبي الحديد: قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ رحمه الله تعالى: الكلمة المذكورة أنّ طلحة لمّا أنزلت آية الحجاب قال بمحضر ممّن نقل عنه إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):ما الذي يعنيه حجابهنّ اليوم! وسيموت غداً فننكحهنّ(3).
كما ذكر في مكان آخر عن عمر أنّه قال في نفس الواقعة: «وأمّا أنت يا طلحة! فقلت: إن مات محمّد لنركضنّ بين خلاخيل نساءه كما ركض بين خلاخيل نساءنا»(4).
وروي خبر تكلّم طلحة مع عائشة عن ابن عبّاس بنحو أكثر تفصيلاً في كلّ
____________
1- وقال النحاس في معاني القرآن ٥: ٣٧٣: «قال معمر: قال هذا «طلحة» لعائشة»، وذكر لفظ «طلحة» هكذا لا يتبادر منه إلاّ طلحة المعروف بين المسلمين.
2- أي: غاضباً.
3- شرح نهج البلاغة ١: ١٨٥.
4- نفس المصدر ٩: ٥٦.
من لباب النقول والدرّ المنثور للسيوطي(1) وفتح القدير للشوكاني(2)، وفيه أنّ ابن عمّ بعض أزواج النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) جاءها وكلّمها، فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) له: «لا تقومنّ من المقام بعد يومك هذا»، ودار بينهما الكلام حتّى مضى الرجل، ثمّ قال: يمنعنى(3) من كلام ابنة عمّي لأتزوّجنّها من بعده!! فأنزل الله هذه الآية.
وأمّا المصادر الشيعيّة فقد تناقلت هذه الرواية أيضاً باختلاف يسير، وقد جاء فيها: «كان سبب نزولها - أي هذه الآية - أنّه لمّا أنزل الله: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾(4).
وحرّم الله نساء النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) على المؤمنين، غضب طلحة فقال: يحرّم محمّد علينا نساءه ويتزوّج هو نساءنا! لئن أمات الله محمّداً لنركضنّ بين خلاخيل نساءه كما ركض بين خلاخيل نساءنا!! فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ الآية(5).
____________
1- لباب النقول: ١٦٣، الدرّ المنثور ٥: ٢١٤.
2- فتح القدير ٤: ٣٠٠.
3- في تفسير الآلوسي ٢٢: ٧٤ جاء لفظ «عنّفني» بدل «يمنعني».
4- الأحزاب -٣٣- : ٦.
5- راجع: تفسير الصافي ٤: ١٩٩، تفسير البرهان ٨: ٦٩، نقلاً عن تفسير القمي، بحار الأنوار ٢٢: ١٩٠ وغير ذلك.
(٨٠) محمّد مداني باه (مالكي / غينيا - كوناكري)
ولد عام ١٣٥٨هـ (١٩٤٠م) بمدينة «مامون» في «غونياكوناكري»، ونشأ في أسرة تنتمي إلى المذهب المالكي ما جعله يحذو حذو أسرته في اتّباع هذا المعتقد.
بعد مضيّ عدّة أعوام وبعد أن توصّل إلى مرحلة يستطيع فيها التمييز والمقايسة بين معتقده الذي نشأ عليه وبين بقيّة المعتقدات، عكف «محمّد» على دراسة عدّة كتب من تأليفات أتباع مدرسة آل البيت(عليهم السلام)، فقرئها ووضعها موضع المقايسة في الميزان ليرى مدى صحّتها بالنسبة لما بنى عليه مبانيه الاعتقاديّة سابقاً، وهو مذهب إمام المالكيّة مالك بن أنس.
من هو مالك؟
ولد أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عام ٩٣ للهجرة، وذلك عن حمل طالت به أمّه ثلاث سنين!!
ذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام» عن معن بن عيسى والواقدي ومحمّد بن الضحّاك هذا القول(1)، كما قال محمّد بن عمر: سمعت مالك بن أنس يقول: قد يكون
____________
1- تاريخ الإسلام ١١: ٣١٩.
الحمل ثلاث سنين، وقد حُمِل ببعض الناس ثلاث سنين، يعني نفسه(1).
عايش مالك بن أنس زوال الدولة الأمويّة وقيام الدولة العباسيّة، وكانت له روابط وثيقة مع أمراء هذه الدولة، حتّى أنّه ألّف كتابه «الموطأ» بناءً على طلب المنصور العباسي له.
يذكر المؤرّخون أنّ مالك بن أنس مات عام ١٧٩ للهجرة عن عمر ناهز الخمسة والثمانين عاماً في المدينة المنوّرة.
وأمّا خصائص مالك فنشير هنا إلى مقتطفات منها:
الأخذ برأي الخوارج:
إحدى المواقف التي اتّخذها مالك وخالف بها رأي المسلمين حينها هو الأخذ بقول الخوارج.
يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي هذا الأمر قائلاً: ومن المشهورين برأي الخوارج...
مالك بن أنس الأصبحي الفقيه، يروى عنه أنّه كان يذكر عليّاً(عليه السلام) وعثمان وطلحة والزبير فيقول: والله ما اقتتلو إلاّ على الثريد الأعفر(2).
ويذكر ابن عبد البرّ رأي مالك هذا ضمن الآراء التي أشكل لأجلها عدّةٌ من علماء المسلمين عليه، ويقول: وعابه ]أي مالكاً[ قوم في كلامه في عثمان وعلي(3).
____________
1- صفوة الصفوة لابن الجوزي ٢: ٥٠٣، ويضيف المصنّف عن قول محمّد بن عمر: وسمعت غير واحد يقول حمل بمالك ثلاث سنين.
2- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٥: ٧٦، العقد الفريد ٢: ٩٩.
3- جامع بيان العلم وفضله ٢: ١٦١.
ترك الرواية عن أمير المؤمنين(عليه السلام) وعدم ذكر مناقبه:
نظراً لاعتقادات مالك الباطلة بشأن أمير المؤمنين(عليه السلام) ترك مالك الرواية عنه(عليه السلام) في كتابه «الموطّأ»، وقد أثار هذا الأمر استغراب الخليفة هارون العباسي، فاستفسره عن سبب ذلك، فقال معتذراً لفعله: لم يكن ببلدي ولم ألق رجاله(1)!!
هذا مع أنّه لم يقتصر على الرواية عن غيره(عليه السلام) كمعاوية بن أبي سفيان وعبد الملك بن مروان بل استند إلى آرائهم أيضاً.
كما روى عن بعض الكذّابين كهشام بن عروة مراراً، مع أنّه يقول: هشام بن عروة كذّاب(2).
وقد نبض عرق النصب عنده أيضاً فلم يذكر في كتبه اي منقبة للإمام علي(عليه السلام).
يقول ابن حبّان: لست أحفظ لمالك ولا للزهري فيما رويا من الحديث شيئاً من مناقب علي(3).
التدليس في سند الروايات:
من الأمور التي تعتبر تدليساً في علم الرواية والحديث هو التصرّف في السند بحذف بعض الرواة بدون الإشارة إلى ذلك.
وممّن نسبت إليه هذه الطريقة مالك بن أنس، فقد جاء في ذكر أخبار المدلّسين عن بعض الرجاليين أنّ ما رواه مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن ابن عبّاس كان ثور يرويه عن عكرمة عن ابن عبّاس، وكان مالك يكره الرواية عن عكرمة فأسقط اسمه من الحديث وأرسله.
____________
1- تنوير الحوالك شرح على موطّأ مالك: ٧.
2- تاريخ بغداد ١: ٢٣٩.
3- المجروحين لابن حبّان ١: ٢٥٨.
ثمّ يقول مصنّف الرواية في علم الدراية: وهذا لا يجوز، وإن كان مالك يرى الاحتجاج بالمراسيل ; لأنّه قد علم أنّ الحديث عمّن ليس بحجّة عنده، وأمّا المرسل فهو أحسن حالة من هذا ; لأنّه لم يثبت من حال من أرسله عنه أنّه ليس بحجّة(1).
الغناء والتغنّي:
تناقلت المصادر التاريخيّة والأدبيّة عن مالك بن أنس أنّه كان ممّن يتغنّى بالآلات.
هذا وقد نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن ضرب بالدفّ والطبل وصوت الزمارة، وقد رووا عنه أنّه قال: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق، والتلذّذ بها كفر(2).
يذكر «الخطيب» في تاريخ بغداد أنّ إسماعيل بن زهري عندما قدم العراق، أكرمه هارون وأظهر برّه، ودار بينهما حديث، وكان ممّا سئل الخليفة أنّه سأل عن مذهب مالك بن أنس في الغناء.
فنقل إبراهيم - في جواب الخليفة - عن أبيه أنّ جماعة اجتمعوا في مدعاة كانت في بني يربوع ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغنّون ويلعبون، ومع مالك دفّ مربّع وهو يغنيهم:
| سليمى أجمعت بينا | فأين لقاؤنا أينا |
| وقد قالت لأتراب | لها زهر تلاقينا |
| تعالين فقد طاب | لنا العيش تعالينا |
____________
1- الكافية في علم الرواية، فصل في ذكر شيء من أخبار بعض المدلّسين: ٤٠٣.
2- نيل الأوطار للشوكاني ٨: ٢٦٤.
فضحك هارون ووصله بمال عظيم(1).
كما نقل عن ابن دحمان الأشقر أنّه قال: كنت بالمدينة، فخلا لي الطريق وسط النهار، فجعلت أتغنّى:
| ما بال أهلكِ يا ربابُ | خُزراً كأنّهُمُ غضاب |
فإذا خوخة(2) قد فتحت، وإذا وجه قد بدا تتبعُه لحية حمراء، فقال: يا فاسق أسأت التأدية... ثمّ اندفع يغنيه... فقلت له: أصلحك الله! من أين لك هذا الغناء؟
قال: نشأت وأنا غلام حدث أتّبع المغنّين وآخذ عنهم، فقالت لي أمّي: يا بنيّ إنّ المغنّي إذا كان قبيح الوجه لم يُلتفت إلى غنائه، فدع الغناء واطلب الفقه، فإنّه لا يضرّ معه قبح الوجه فتركتُ المغنيّن واتّبعتُ الفقهاء... فقلت له: فأعد جعلتُ فداك! قال: لا ولا كرامة! أتريد أن تقول: أخذته عن مالك بن أنس! وإذا هو مالك بن أنس ولم أعلم(3).
الروابط المتقابلة بين مالك والحكومة:
يعكس التاريخ الإسلامي حالة من التعاطي المزدوج بين الحكومة العباسيّة من جهة وبين مالك بن أنس من جهة أخرى.
فقد كان مالك يدخل على السلاطين(4) ويؤيّد حكمهم وإن كانوا ظلاّماً
____________
1- تاريخ بغداد ٦: ٨٢، كما نقل هذه الواقعة أبو الفرج الأصفهاني في اغانيه ٢: ٤٨٦، عن إبراهيم بن سعد أنّه حلف للرشيد أنّه سمع مالكاً يغنّي:
سلمى أزمعت بينا *** فأين تقولها أينا
في عرس رجل من أهل المدينة يكنّى أبا طلحة.
2- الخوخة: البويب، أو الباب الصغير في الباب الكبير.
3- الأغاني ٤: ٤٠٩.
4- راجع العلل لأحمد بن حنبل ١: ٥١١.
جائرين استولوا على أموال المسلمين بالقهر والغلبة، كما يبيّن ذلك قول عبد الرحمن ابن صالح صاحب مالك، فإنّه قال: قيل لمالك: إنّك تدخل على السلطان، وهم يظلمون ويجورون؟! قال: يرحمك الله فأين التكلّم بالحق(1)!! ولم يَرَ غير هذا التوجيه لفعله هذا.
ويسرد مالك نفسه قصّة طويلة يذكر فيها دخوله على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور في منى(2).
ومن الطبيعي حينئذ أن يحاول العباسيّون أن يجعلوا منه مرجعاً عامّاً للأمّة في الفتوى مهما كلّف ذلك من مخالفات ; لأنّ الأُمّة بذلك تبتعد عن المسير الذي رسمته العترة الطاهرة(عليهم السلام)، وتخضع لسيطرتهم أكثر من ذي قبل، وإذا اجتمع الأمران وهدأ الناس وأخمدت ثوراتهم ببعض الفتاوى كالقول: بوجوب إطاعة الله، والرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)وأولي الأمر وهم الحكّام، فسيستطيب الحكم للخلفاء، ولا يقف أيّ كان أمام سطواتهم وتجبّرهم.
وفي هذا السياق ينقل لنا التاريخ أنّ منادي السلطة كان ينادي بالمدينة: ألا لا يفتي الناس إلاّ مالك بن أنس(3).
كما طلبوا من مالك أن يؤلّف لهم كتاباً يجمعوا الناس عليه، فقد قال المنصور الدوانيقي لمالك في حديث دار بينهما: والله لو بقيت لأكتبنّ قولك كما تكتب المصاحف
____________
1- تاريخ الإسلام ١١: ٢٣٧.
2- راجع الإمامة والسياسة: ٢٠١.
3- أضيفت إلى هذا الجملة عبارة «وعبد العزيز بن أبي سلمة» في تاريخ بغداد ١٠: ٤٣٦، تذكرة الحفاظ ١: ٢٢٢ وغيرها، كما أضيفت عبارة «وابن أبي ذئب» في ما رواه الأكابر عن مالك: ٦١، تاريخ الإسلام ١١: ٣٣١ ومصادر أخرى.
والأبعثنّ به إلى الآفاق فاحملهم عليه(1)... وآمرهم أن يعملوا بما فيه، ولا يتعدّوا إلى غيره(2).
وعندما قال له مالك: إنّ أهل العراق لا يرضون علمنا، ولا يرون في عملهم رأينا، أجابه المنصور بكل غطرسة: يُحملون عليه وتُضرب عليه هاماتهم بالسيف، ونقطع طيّ ظهورهم بالسياط(3).
ثمّ في زمن الخليفة هارون أراد هارون أن يعلّق الموطأ على الكعبة ويحمل الناس على ما فيه(4).
كما نقل عن المأمون العباسي أنّه عندما أراد السفر قال لمالك: تعال معنا، فإنّي عزمت أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان الفاس على القرآن(5).
وبهذا نفهم كيف انتشرت المذاهب التي ابتدعتها السلطات الحاكمة تحت تغطيات دينيّة وسمّتها بمذاهب أهل السنّة والجماعة.
كما قد حظي مالك بعطاء الأمراء الذين قلّما ينفقون منه على غير متّبعيهم ومُشيّدي سياستهم، فكانت الدنانير تدرّ عليه بكثرة.
فأمر له المنصور مرّة بألف دينار عيناً ذهباً، وكسوة عظيمة، ولابنه أيضاً بألف دينار(6).
____________
1- تاريخ الإسلام ١١: ٣٢٤.
2- كشف الظنون ٢: ١٩٠٨، الإنتقاء: ٤١.
3- راجع: الإمامة والسياسة: ٢٠٢.
4- كشف الظنون ٢: ١٩٠٨.
5- تاريخ مدينة دمشق ٣٢: ٣٥٦.
6- الإمامة والسياسة: ٢٠٣.
وأعطاه هارون أخرى ألف دينار له وألفاً لابنه(1).
كما وهبه المأمون ثلاثة الآف دينار(2).
وعندما قدم المهدي العباسي إلى المدينة بعث إلى مالك بألفي أو ثلاثة آلاف دينار(3)، كما انه عندما رأى المهدي كتب الموطأ مدوّنةً أمر له بأربعة آلاف دينار ولابنه بألف دينار(4).
ومن الطبيعي أن لا يُعامل غيره هذه المعاملة ولم يمتز بكلّ هذا العطاء، فقد قدم ابن جريح مرّة على المنصور وقال له: إنّي قد جمعت حديث جدّك عبد الله بن عبّاس وما جمعه أحد جمعي، فلم يعطه شيئاً(5).
الجهل بالمسائل الشرعيّة:
عُرف مالك بن أنس في أوساط مجتمعه وعند من ترجم له بكثرة الاستفادة من كلمة «لا أدري» و«لا أحسن» تهرّباً عن الإجابة.
ومع هذا لا يُدرى كيف وبأيّ ذريعة وضع مالك نفسه موضع الإفتاء بين الناس!
فقد جاءه رجل من مسيرة ستّة أشهر حاملاً معه مسئلة من أهل بلاده، فما أن سأله عنها حتّى أجاب مالك: «لا أحسن»(6).
____________
1- العقد الفريد ١: ٢٣١، وقال: فلقد مات مالك وتركها لورّاثه في مزود.
2- تاريخ مدينة دمشق ٣٢: ٣٥٦.
3- تاريخ الإسلام ١١: ٣٢٤.
4- الإمامة والسياسة: ٢٠٣.
5- العلل لأحمد بن حنبل ٢: ٣١٢.
6- راجع تاريخ الإسلام ١١: ٣٣٠.
والأخبار بذلك كثيرة منها ما نقله خالد بن خداش حيث قال: قدمت على مالك من العراق بأربعين مسألة، فسألته عنها فما أجابني إلاّ في خمس(1).
ويقول الهيثمي بن جميل: شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة قال في اثنين وثلاثين منها: «لا أدري»(2).
الفتوى بالرأي وبكاؤه لأجلها:
يعدُّ خبر بكاء مالك لأجل الفتوى بالرأي من الأمور المشهورة بين المؤرّخين فقد نقل هذا الخبر ابن وهب قائلاً: سمعت مالكاً يقول: لقد حدّثتُ بأحاديث وددتُ أنّي ضربت بكلّ حديث منها سوطين ولم أحدّث بها(3).
ثمّ إنّه كان يبكي في مرضه الذي مات فيه على عمله هذا... ومن أحقّ منه بالبكاء؟! وأنّى تنفع الندامة وقد عمل بما قاله برأيه جمع وماتوا على ذلك...؟!
قال حدث القعنبي: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه، فسلّمت عليه ثمّ جلست، فرأيته يبكي، فقلت: يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟
فقال لي: يابن قعنب! ومالي لا أبكي؟! ومن أحقّ بالبكاء منّي؟! والله لوددت أنّي ضربت لكلّ مسألة أفتيت فيها برأيي بسوط سوط، وقد كانت لي السعة فيما سبقت إليه، وليتني لم أفت بالرأي(4).
وقد أنذره الليث بن سعد على هذا الأمر وعدّد عليه عدّة مسائل كلّها مخالفة لسنّة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) ومن التي قال فيها مالك برأيه.
____________
1- الانتقاء: ٢٠.
2- الانتقاء: ١٩.
3- تاريخ الإسلام ١١: ٣٢٥، معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري: ٦١.
4- وفيات الأعيان ٤: ١٣٧، شذرات الذهب ١: ٤٦٨.
يقول الليث بن سعد: أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلّها مخالفة لسنّة النبيّ ممّا قال فيها مالك برأيه، ولقد كتبت إليه في ذلك(1).
تكلّم الأعلام فيه:
وهذا... وقد تكلّم في مالك وعابه جماعة من أعلام الأئمّة:
فقد قال فيه سفيان الثوري: مالك ليس له حفظ(2).
وقال ابن عبد البرّ: تكلّم ابن أبي ذؤيب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة كرهت ذكره، وهو مشهور عنه(3).
وقال أيضاً: كان إبراهيم بن سعد يتكلّم فيه ]أي في مالك[ ويدعو عليه(4).
كما تكلّم في مالك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن أبي يحيى وابن أبي الزناد، وأعابوا أشياء من مذهبه(5).
وقد سأل سنديّ مالكاً عن مسألة فأجابه، فقال ]سنديّ[: أنت من الناس أحياناً تخطئ وأحياناً لا تصيب! قال: هكذا الناس(6).
وقال ابن مبارك عن مالك: لم أره علماً(7).
وقد نقل الخطيب عن بعض العلماء: أنّ مالكاً عابه جماعة من أهل العلم في
____________
1- جامع بيان العلم وفضله ٢ك ١٤٨.
2- تاريخ بغداد ٩: ١٦٤.
3- جامع بيان العلم وفضله ٢: ١٦٠.
4- نفس المصدر ٢: ١٦١.
5- نفس المصدر.
6- تاريخ الإسلام ١١: ٣٢٦، ٣٣١.
7- جامع بيان العلم وفضله ٢: ١٥٧.
زمانه(1)، وعن عبد الله بن منافع: كان ابن أبي ذؤيب وعبد العزيز الماجشون وابن أبي حازم ومحمّد بن إسحاق يتكلّمون في مالك بن أنس، وكان أشدّهم فيه كلاماً محمّد بن إسحاق(2).
مقتطفات من معاملاته الشاذّة مع الناس:
* جاء رجل إلى مالك بن أنس وأنا - يحيى بن خلف - شاهد، فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول في رجل يقول: القرآن مخلوق؟ قال: كافر زنديق خذوه فاقتلوه! قال: إنّما أحكي لك كلاماً سمعته، قال: لم أسمعه من أحد، إنّما سمعته منك(3)!
* دخل عبد الله بن عمر بن الرمّاح على مالك، فقال له: يا أبا عبد الله ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنّة؟ فقال مالك: هذا كلام الزنادقة! أخرجوه(4).
* كان مالك جالساً فساله رجل عن (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) كيف استواءه؟ فأجابه مالك باختصار ثمّ قال: أنت رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه، فأخرج الرجل(5).
* قال إسماعيل الفزاري: دخلت على مالك وسألته أن يحدّثني، فحدّثني اثنى عشر حديثاً ثمّ أمسك، فقلت: زدني أكرمك الله، وكان له سودان قيام على رأسه فأشار إليهم فأخرجوني من داره(6).
____________
1- تاريخ بغداد ١: ٢٣٩.
2- نفس المصدر.
3- نفس المصدر ٢: ٣٧٧.
4- تاريخ الإسلام ١١: ٣٢٦، سير أعلام النبلاء ٨: ١١٤.
5- راجع: تاريخ الإسلام ١١: ٣٢٨.
6- الانتقاء: ٤٢.
ويبعث سلوك مالك هذا على التساؤل عن سبب بخل مالك واقتناعه بما ينفع الناس من أحاديث نبويّة وإرشادات تربويّة، وعن سبب نفاد صبره وكلماته المسيئة للسائل؟!
هذا... وإنّ قاطبة الأُمّة تتّبع العلماء في دينها وسلوكها، فما هو المتوقّع منها بعدئذ؟!
المقارنة بين المذهبين:
بعد أني تعرّف «محمّد» على الكتب الدينيّة للمذهب الجعفري، وقارنها بكتب المذهب المالكي توصّل إلى أنّ عقائد المذهب الشيعي تنطبق والمسير الذي ارتآه الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) للمسلمين، ولكنّ الغالبيّة ولأسباب شتّى انحرفت عن ذلك المسير.
فقرّر «محمّد» الاستبصار، وأعلن ذلك عام ١٤١٣هـ (١٩٩٣م) في الحوزة العلميّة الشيعيّة في مدينة «كوناكري».
 |  |