

(22) صبري أحمد علي موسى
(سني / مصر)
ولد عام 1944م في المنصورة بجمهورية مصر العربية، نال شهادة ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة عام 1969م، ثم أصبح عضواً في رابطة الجامعات الاسلامية، درس الدراسات العليا في النظم السياسية والاقتصادية والقانونية لمدة عامين بمعهد البحوث والدراسات الاسيوية، جامعة الزقازيق، وعيّن عام 1995م محامياً بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
اهتمامه بالبحث:
كان دأب المحامي صبري الاهتمام بالبحث حول الأديان والمذاهب، فلهذا كرّس لفترة طويلة جهده في البحث حول العقائدة الإلهية في الديانات السماوية والمذاهب الكبرى الاسلامية، وحاول المحامي صبري خلال بحثه عن الحقيقة أن تنبض في شرايينه دماء التجرّد والنزاهة، وأن لا تكون مطالعاته مجرّد ترف فكري أو عمل لا جدوى منه، فلهذا حاول أن يوصله البحث إلى قناعات يشيد عليها مرتكزاته الفكرية ويبني عليها دعائمه العقائدية، فتحرّر من كل فكرة سابقة قبل الشروع بالبحث والتقصي عن أية حقيقة، وحكّم عقله حين المقارنة بين الرؤى التي يواجهها خلال البحث.
البحث في الامامة:
واصل المحامي صبري بحثه في الأمور العقائدية حتى بلغ مبحث الامامة، فسلّط الأضواء على مسألة الخلافة الاسلامية في الشريعة والفقه والقانون، وتأمل في الأقوال التي ذهبت إليها شتى المذاهب الاسلامية في هذا الجال، وطالع أدلة الذين يقولون أنّ الإمامة تكون بالاختيار، وتأمل في أدلة الذين يقولون أنّها بالنص والتعيين، ثم صفّح النظريات الكلامية لدى المذاهب عموماً، وراجع المراجع الاساسية والمصادر المعتمد عليها، ثمّ درس بعمق فقه الخلافة الاسلامية والنظريات الفلسفية في شأن الإمامة بين المذاهب الكبرى الدينية، ثم عرض جميع الآراء التي حصل عليها على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه(صلى الله عليه وآله)، فرأى أن النتائج تفرض عليه التخلي عن معتقداته السابقة، لأنه وجد نفسه امام براهين تخالف ما كان عليه.
نتائج غير متوقعة:
أعادَ المحامي صبري النظر فيما قام به من دراسة حول مسألة الإمامة، ليصل إلى مرحلة الاطمئنان من صحة ما توصل إليه فيما سبق، وتأمل مرة اخرى في التاريخ الاسلامي، ولا سيما بعد وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله)، وتثبّت من صحة الأحاديث المروية عن رسول الله في شأن الإمام علي(عليه السلام) وأهل البيت(عليهم السلام)، فوجد مرة أُخرى أنّ ما توصل إليه يخالف ما عليه جمهور أهل السنة، ووجد أن ما ذهب إليه الشيعة في الامامة مستوحاة من الكتاب والسنة.
ثم درس المحامي صبري هذه المسألة من الناحية العقلية، فتوصّل إلى أن وجود الامام المنصوص عليه بعد النبي الأعظم والمسدّد من قبل الله سبحانه وتعالى، مسألة لابد منها من أجل حماية الشريعة من التحريف واتمام الحجة وصيانة المجتمع من التيه والضياع.
اتخاذ القرار النهائي:
التفت المحامي صبري بعد فترة طويلة من انشغاله بالبحوث العقائدية والفكرية أن الأدلة والبراهين تملي وتضغط عليه من جميع الأطراف أن يتخلّى عن معتقداته السابقة التي استقاها من أهل السنة، فاندفع للالتحاق بركب مذهب أهل البيت(عليهم السلام).
وبما أن المحامي صبري كان ذو نفس موضوعية، فلم يجد بُداً سوى اعتناق مذهب أهل البيت(عليهم السلام)، ففعل ذلك ثم بدأ حياته من جديد وفق تعاليم عترة الرسول(صلى الله عليه وآله) وشرع ينهل من ينبوع علومهم ومعارفهم العذبة.
وفاته:
استمر المحامي صبري على ولائه لأهل البيت(عليهم السلام) واجتهد بعد الاستبصار أن تكون له مشاركة فاعلة في نشر مفاهيم وقيم ومبادىء أهل البيت(عليهم السلام)، كما أنه كان يدافع عن مصالح وحقوق المستضعفين) وبقي المحامي صبري على حماسه ومثابرته في نشر مذهب أهل البيت(عليهم السلام) حتى اعتراه مرض شديد سلب منه القدرة على العمل، ولم تمض مدة حتى انتقل إلى رحمة الله في شهر صفر عام 1422هـ عن عمر يناهز 56 عاماً، فتغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته.
مؤلفاته:
(1) "علامات القيامة ونهاية العالم في الديانات السماوية والمذاهب الاسلامية":
الأول: العلامات الصغرى لنهاية العالم.
الثاني: العلامات الكبرى لنهاية العالم.
(2) "ترقبوا ظهور منقذ البشرية الامام المهدي(عليه السلام) قريباً جداً!!":
بحث ديني علمي مقارن بين اليهودية والمسيحية والعقيدة الاسلامية والمذاهب الكبرى الدينية (لا سيما أهل السنة والشيعة الامامية)، والواقع العالمي المعاصر.
(3) "احذروا خروج المسيح الدجال الزعيم المنتظر للصهيونية العالمية في القريب العاجل!!":
وهو بحث ديني ودراسة علمية مقارنة بين اليهودية والمسيحية والإسلام والمذاهب الدينية على ضوء الوقائع والأدلة العصرية والارهاصات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والكونية.
(4) "ترقبوا نزول السيد المسيح(عليه السلام) في عصر الإمام المهدي(عليه السلام) واقامة الدولة الاسلامية العالمية":
وهو أيضاً دراسة دينية علمية تحليلة مقارنة.
(5) "موسوعة العقائد الإلهية بين الأديان السماوية والمذاهب الاسلامية الكبرى": مخطوط.
تحتوي هذه الموسوعة على عدة كتب وهي:
الكتاب الأول: عن عقيدة التوحيد والايمان بالله.
الكتاب الثاني: عن عقيدة الايمان بالملائكة وعالم الجن والشياطين.
الكتاب الثالث: عن عقيدة الايمان بالكتب السماوية.
الكتاب الرابع: عن عقيدة الايمان بالنبوة والأنبياء.
الكتاب السادس: عن عقيدة الايمان بالقضاء والقدر والعدل.
الكتاب السابع: عن عقيدة الايمان بوجوب الامامة والخلافة وولاية أئمة أهل البيت(عليهم السلام).
وهذه الكتب بدورها مقسّمة لأجزاء عديدة (تربو على تسعة عشر جزءاً).
وقفة تعريفية لـ : ((موسوعة العقائد الإلهية بين الأديان السماوية والمذاهب الإسلامية الكبرى))
تتضمن هذه الموسوعة الحديث باسهاب واستفاضة عن دراسة مقارنة في الديانات السماوية والمذاهب الكبرى الاسلامية في مجال العقائد الالهية السماوية.
وتنقسم هذه البحوث المقارنة إلى سبعة كتب، ويتضمّن كل كتاب عدة أبواب ومباحث.
ويرتبط الكتاب الأول بعقيدة التوحيد والايمان بالله عزوجل، ويتطرّق فيه المؤلف إلى عدة أبواب منها عقيدة الايمان بالله، وحاجة البشرية إلى العقيدة السماوية وضرورتها الحتمية، وأهمية علم العقائد الاسلامية، وضرورات الايمان وصلته بالعلم والفكر الانساني المعاصر، وعلم الكلام ومناهج الدراسة العقائدية لدى أهل السنة والمعتزلة والشيعة الامامية.
ويتطرّق المؤلف في هذا الكتاب أيضاً إلى حقيقة الايمان والاسلام ومزايا العقيدة الاسلامية وآثارها الايجابية في حياة الافراد والمجتمعات الانسانية، وعقيدة التوحيد الايمانية بين الحقائق الثابتة والتاريخية، وتصورات الأمم الضالة الوهمية والطبيعة الانسانية.
ويشير المؤلف في نهاية هذا الكتاب إلى مفاهيم الايمان ودعائم العقيدة الدينية في المذاهب الكبرى الإسلامية، وحقيقة الايمان ودعائمه الاساسية لدى أهل السنة والشيعة الامامية.
وأيضاً حول العلاقة الوثيقة بين الملائكة والانسان والمفاضلة بينهم وبين البشر وما جاء في ذلك من أقوال وتحقيق بيان.
ويتعرّض المؤلف خلال ابحاثه إلى التعريف باحوال الملائكة الكرام وتنوع وظائفهم وخصائصهم كما جاء في الكتاب وبيان خير الانام، ثم يتطرق إلى عالم الجن والشياطين ويتحدّث حول عالم الجن والشياطين في الكتب السماوية وفي ضوء القرآن والسنة النبوية، واسباب العداء بين الانسان والشيطان، واسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان، والأمراض النفسية كمدخل لاغوائه للبشر.
ثم يتطرّق المؤلف إلى التنظيم الاداري للدولة الابليسية وجذور الشر والفتنة في عالم الجن والشياطين. وفي نهاية هذا الكتاب يبيّن المؤلف أقوال أئمة أهل البيت(عليهم السلام) وتفسيرات علماء الشيعة الامامية حول عالم الجن والشياطين.
ويرتبط الكتاب الثالث بالكتب السماوية والالهية، ويحتوي هذا الكتاب عقيدة المؤمن وأدلة ايمانه بالكتب السماوية والكتب الإلهية المعروفة والمجهولة، ويتضمن أيضاً محاضرات في النصرانية والأدوار التي مرّت عليها عقائد النصارى وعن كتبهم ومجامعهم المقدّسة والمسيحية كما جاء بها المسيح(عليه السلام)، والفرق المسيحية التي ظهرت في عصر التوحيد وضياع معالم التوحيد الاساسية.
الدين عند موسى وعيسى ومحمد(صلى الله عليه وآله)، والغفران بين الاسلام والمسيحية، ثم يبيّن المؤلف الاسلام والديانات السماوية وضوابط التقريب ومحاذيره بين اتباع العقائد الايمانية، ثم يشير إلى عالمية الدعوة الاسلامية والرسالة المحمدية إلى شعوب الأرض قاطبة، ثم يشير إلى مدارس التفسير القرآني والاتجاه
وفي نهاية هذا الكتاب يقدّم المؤلف بحثاً حول بيان معالم الاعجاز الالهي في القرآن الكريم لدى المذاهب الكبرى الاسلامية، ثم يلحقه ببحث حول المرجعية العليا الاسلامية للقرآن الكريم والسنة النبوية، ويرتبط الكتاب الرابع بالنبوة والأنبياء(عليهم السلام)، ويحتوي هذا الكتاب على عدّة أبواب، منها: النبوة والأنبياء في ضوء الكتاب والسنة وحاجة البشرية للأنبياء، وعصمة الأنبياء والرسل بين أهل السنة والشيعة الامامية، والفلسفة والنبوة ومعجزات وصفات الأنبياء بين أهل السنة والشيعة، ومعجزات الأنبياء وخوارقهم لدى الشيعة، ومن انباء المرسلين والدعاة إلى الله رب العالمين.
ثم يطرح المؤلف بحثاً حول المسيح في مصادر العقائد النصرانية والاسلامية، وإثبات بشريته من خلال نصوص التوراة وفي أناجيل العهد الجديد، وبطلان عقيدة النصارى في حقيقة السيد المسيح والخلاص العظيم بالأدلة القطيعة من خلال نصوص الأناجيل الأربعة، والمسيح بين نصوص الانجيل والقرآن والسنة النبوية من طريق أهل السنة والشيعة الامامية.
ويرتبط الكتاب الخامس حول المعاد واليوم الآخر، ويحتوي هذا الكتاب على عدّة أبواب منها: بديع صنع الله في جسم الإنسان، وأسرار الروح والجسد والموت والحياة، ومشاهد الناس المختلفة، وأهل التحقيق من الأنبياء والأئمة والعلماء ووصاياهم عند الممات، وأسرار الموت وشدائده ومقدماته الضرورية
ويرتبط الكتاب السادس بالقضاء والقدر والعدل الالهي، ويحتوي هذا الكتاب على عدّة أبواب، منها أنّ الايمان بالقضاء والقدر من أصول العقائد الاسلامية اليقينية، وأنه عقيدة ايمانية تربوية خالصة.
ثم يطرح المؤلف بحثاً حول حيثيات الدفاع عن قضية العدل الالهية، وحرية الارادة والاختيار الانسانية، ومشكلة الجبروحرية الاختيار بين الشرائع السماوية والمذاهب الاسلامية، وفي نهاية هذا الكتاب يطرح المؤلف قضية الجبر والعدل والالهي والحرية الانسانية في الفكر الاسلامي المعاصر بين علماء أهل السنة والصوفية والشيعة الامامية.
ويرتبط الكتاب السابع بوجوب الامامة والخلافة الاسلامية، ويتضمن هذا الكتاب عدّة أبواب منها: قضية الامامة والخلافة وتطوراتها التاريخية، ومدى وجوبها شرعاً في المذاهب الاسلامية الكبرى، ثم يعقبه بمبحث نظام الخلافة واسس اختيار الامام أو الخليفة لدى المذاهب الاسلامية الاعتقادية، ومبحث فقه الخلافة الاسلامية، والنظريات الفلسفية في شأن الامامة بين المذاهب الكبرى الدينية والاعتقادية، ومبحث الحكومة الاسلامية وصلاحيات ولاية الخليفة، والمبادىء الاساسية لنظام الحكم في الدولة الاسلامية من المنظور العقائدي والفقه السياسي والدستوري الاسلامي، ثم يتطرّق حول قضية الامامة والخلافة الاسلامية لدى الاسماعيلية والشيعة الامامية، ثم يبحث المؤلف حول وحدة الأمة الاسلامية ويبين جملة من المفاهيم الدينية المشتركة بين أهل السنة والشيعة
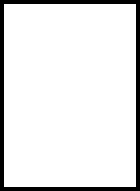
(23) طارق زين العابدين
(مالكي / السودان)
من مواليد السودان، نشأ في أسرة تعتنق المذهب السني، كان منذ صغره مهتماً بصياغة أفكاره ورؤاه وفق الأسس والمبادىء السليمة واليقينية، فدفعه هذا الأمر إلى البحث والتحقيق في المذاهب الإسلامية حتى لاح بصره نور معارف أهل البيت(عليهم السلام) فاشتاق لنيل المزيد من هذه المعارف، فلم يجد أرضية مناسبة لتلقي هذه العلوم سوى دولة ايران، فسافر إليها والتحق فيها بكلية الإلهيات والمعارف الإسلامية في مدينة مشهد.
ومن هنا تجلّت الحقائق التاريخية له، وتوصّل إلى قناعات جديدة ترتبط بالاعتقاد والمصير الأبدي، فلهذا لم يجد مجالا للمساومة أو المماطلة، فاعتنق مذهب التشيّع بعد الاعتماد على الأدلة والحجج والبراهين المقنعة.
دوافع توجهه للبحث:
أدرك الأخ طارق بعد وصوله إلى مرتبة النضج الفكري بأنّ الدين الإسلامي هو نظام الحياة الذي به يحدّد الإنسان المؤمن المسار الذي ينبغي أن يسير على ضوءه في هذه الدنيا، فلهذا لابد أن يقوم هذا الاعتقاد على أساس يبعث اليقين والطمأنينة، ولا يصح أن تنال المصائر بالظنون والتوهمات، أو تنال بالتقليد
يقول الأخ طارق في هذا المجال: "لابد من التحقيق من سلامة العقيدة بالفحص واعادة النظر وتقليب البصر وإعمال الفكر والتدبّر في أحوالها، لأنّ العقيدة لا تورث حتى ندعها للفطرة وحدها، والاتّكاء على اعتقاد الاسلاف والآباء والاجداد ممنوع، وقد قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَ لَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْـاً وَلاَ يَهْتَدُونَ )(1)".
ويضيف الأخ طارق: "إنّ الرسول(صلى الله عليه وآله) قد صرَّح محذِّراً أُمَّته إذ يقول(صلى الله عليه وآله): "افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أُمَّتي على ثلاث وسبعين فرقة" إذن فالاختلاف الذي وقع بين المسلمين إلى اليوم يؤيّد ما ذهبنا إليه في وجوب التحقيق والبحث في ما بلَغنا من اعتقاد، وإلاّ فكيف نطمئنّ على حصول السلامة وبلوغ النجاة؟ وكيف نثبت ذلك ونقيم عليه الدليل والحجّة؟ هذا أمر لا أظنُّ سيستَهْوِنه مسلم ارتبط مصيره بيوم فيه حسابٌ ثمَّ ثواب أو عقاب، ولا أظنُّ إنساناً صدَّق باليوم الآخر ولا يرجو فيه النجاة والسلامة، فالتحقيق والبحث هو السبيل إلى بلوغ هذه الغاية والحصول على النجاة المطلوبة.
وما يجدر الإشارة إليه أنَّ الذين يُفجَعون بالمصير السيّء والنهاية المشؤومة
____________
1- المائدة: 104.
وهؤلاء إمَّا أنّهم قد أطلقوا للنفس زمامها وحبلها على غاربها بالتهاون والتساهل في أمر الدين ونسيان الحياة الآخرة وعدم مراعاة أمرها بتصحيح اعتقاد أو أداء تكليف، أو أنّهم ركنوا إلى الأوهام في اعتقادهم وغاصوا في بحار التوهّم بحثاً عن اللؤلؤ، دون أن يتفطّنوا إلى أنَّ اعتقاداً كهذا لا وجود له حتّى يأتي باللؤلؤ النفيس، فليس الوهم إلاّ عدم محضّ لا يوجد إلاّ في الخيال.
أو أنّ هؤلاء قد استلْقَوا في أحضان الظنِّ في أمر العقيدة. وذاقوا بهذا يسيراً من مذاق الحقيقة بعد اختلاطها بقدر جمٍّ من الباطل، وهم في غمرة هذا المذاق الحلو الذي يتلمّظونه بين كَمٍّ من المرارة ركنوا لمذاق الباطل الذي خلطوه به ظنّاً منهم أنَّ للحقِّ مذاقاً كهذا إذ أنَّهم خلطوا عملا صالحاً بآخَر سيّئاً (إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْـاً )(1).
والذين يمحِّصون اعتقادهم الديني ليبلغ حدّ اليقين أو قدراً من اليقين تَضعُف نسبة الشكّ والظنّ فيه بصورة تجعل مقدار الشكّ لا يؤدّي وجوده إلى زوال الطمأنينة في الاعتقاد، فهؤلاء أقرب من غيرهم إلى النهج الذي رسمه النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله) لكي يسير عليه الناس، بل هؤلاء لا يعجزون عن التماس الأدلّة والحجج القويّة على اعتقادهم هذا من حيث موافقته لآيات القرآن وأحاديث النبيّ(صلى الله عليه وآله)ومسلّمات العقل وفطريّاته، فهم في حقيقة الأمر يأنسون، في اعتقادهم الممحّص هذا، إلى التفسير السليم لنقاط الخلاف بينهم وبين الفرق الأُخرى، تفسيراً يخلو من التكلّف الذي لا يُرتضى أبداً في مثل هذه المواقف، بل يقفون
____________
1- النجم: 28.
متطلبات التحقيق في أمر العقيدة:
يقول الأخ طارق حول شروط البحث في الأمور العقائدية:
"إنّ مَن حَزَم الأمر على التحقيق والبحث في اعتقاده فهو لا يستطيع إحراز شيء من تحقيقه إن كان مفعماً بالتعصّب والتقليد اللذين لا يتيحان الفرصة للتحقيق الحرِّ، فلابدَّ له لكي يكون حرّ الحركة والتفكير أن يفرّغ نفسه من كلّ ما يمكن أن يتسبّب في إفساد التحقيق عليه والحيلولة بينه وبين ما يصبو إليه من بحثه، وأن يهيّىء نفسه جيّداً لتقبّل الحقيقة التي يصل إليها، بعد إنجاز التحقيق والاطمئنان إلى سلامته من حيث المنهج السليم والأدلّة المقنعة بلا شكّ; لأنَّ الخوف من خوض التحقيق أو الخوف من تقبّل النتيجة عدوّ المحقّق النزيه، فالنتيجة تحتّم عليه رحابة الصدر لتقبّلها باعتبار أنَّها الحقّ، بل تحتّم عليه الدفاع عنها وعرضها على الآخرين. ومن لا يهدف إلى هذا من تحقيقه وبحثه فعليه ألاّ يشرع في شيء من التحقيق لأنَّه يكون عندئذ مضيعة لوقته، بل يكون عبثاً ولعباً، ولماذا يتحمّل المشاقّ ويقطع الحجّة على نفسه ثمَّ لا يقبل نتيجة بحثه وتحقيقه ولا يدافع عنها؟!".
الأسباب الموجبة للتحقيق في أمر العقيدة:
يقول الأخ طارق حول الأسباب التي دفعته للبحث والتحقيق في أمر العقيدة:
"لا شكّ أنَّ ما ندين به من عقائد يحتوي على قدر جيِّد من الحقيقة، بل
وهذا هو السبب الذي لا نستطيع معه أن نقطع بأنَّ ما ندين به يشتمل بلا ريب على اليقين دون الظنّ، وكثير من الأسباب أدّت إلى عدم القطع هذا فكان دافعاً للتحقيق والبحث، ومن هذه الأسباب:
أوّلا: الفتن والاختلافات الحادّة
إن الفتن والاختلافات التي عصفت بالمجتمعات والأفراد المسلمين، منذ نعومة أظافر الإسلام. وقد بدأت هذه الاختلافات والنبيُّ(صلى الله عليه وآله) لمّا يرتحل من بين الناس آنذاك، فلقد اختلفوا في أهمّ مسألة ترتبط بمصير المسلمين وهم جلوس في حضور نبيّهم(صلى الله عليه وآله)، وهو الاختلاف الذي عُرِف فيما بعد بـ "رزية يوم الخميس". ولا تخلو من حكايته كتب السِّير والأحاديث. ولا شكّ أنَّ هذا الاختلاف قد ألقى بظلاله على زماننا، وأُحيطت الحقيقة على أثره بقدر من الإبهام أدّى إلى صعوبة التعرّف عليها بعينها، ولا سيّما بعد افتراض عدالة كافة الصحابة الذين كانوا أوّل من أختلف في أُمور الدين، فقد أسدلت هذه العدالة الشاملة ستاراً معتماً على كثير من الأُمور، ومنعت التطرّق إلى البحث والتحقيق فيما وقع بين الصحابة من اختلاف بهدف إدراك الحقيقة، فتهيّب الناس السؤال عمّا حَدَث لمعرفة الحقّ من الباطل. وبسبب هذه العدالة استوى عند المسلمين في هذا العصر الخطأ والصواب! لأنَّ المتخالفين من الصحابة كلّهم مأجورون ومُثابون! فانتشر الإسلام على هذا،
ثانياً: تعدّد الفرق الإسلاميّة
ذلك أنّ اختلافاً كهذا حَدَث بين الرعيل الأوّل ـ ولا سيّما بعد الركون إلى عدالتهم كافّة ـ قد أدّى إلى بروز فرق لا تحصى ولا تعدّ في المجتمع الإسلاميّ. والعجيب أنَّ أعضاء هذه الفرق ـ وهم لا يجوّزون بحث الخلاف بين الصحابة ـ تراهم يبحثون حول ما حدث بينهم أنفسهم من اختلاف، وقد غفلوا عن أنَّ اختلافهم هذا كثير منه معلول الاختلافات الأُولى; فإثبات الحقّ لفرقة وسلبه عن فرقة أُخرى، هو في الواقع نسبة ذلك الحقّ إلى رأي من آراء بعض الصحابة في المسألة المختلف فيها، وسلبه عن الفرقة الأُخرى هو سلب هذا الحقّ عن البعض الآخر منهم في نفس مسألة الاختلاف، وقد طعنوا بذلك في عدالة كافّة الصحابة من مكان بعيد.
ثالثاً: بعد المسافة الزمنيّة بين زماننا وزمان النبيّ(صلى الله عليه وآله)
وهذا من الأسباب القويّة التي تؤدّي بلا شكّ إلى بعث غريزة التحقيق والبحث في أُمور الدين، لأنَّ ما صدر من النبيّ(صلى الله عليه وآله) لابدَّ له أن يطوي كلّ تلك المسافة متنقّلا بين أنواع أفراد البشر والمجموعات المتخالفة التي لا تعتمد إلاّ ما وافق الرأي منها ولا تحتفظ إلاّ بما تراه صواباً.
وهي في تحديدها الصواب من الخطأ تتنازعها أُمور وتتناوشها أشياء; فالنسيان والخطأ والهوى والتقليد والعصبيّة والقبليّة والحقد... كلّ ذلك سيضع آثاره على ما رُوي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) من كلام، وجب علينا التعبّد به ونحن في هذا العصر البعيد عن زمن الرسالة. فالذين ينقّون ما يمرّ عبرهم من أقوال وأفعال صدرت عن النبيّ(صلى الله عليه وآله).. على أيّ معيار يعتمدون في هذه التنقية؟ ومَن يجرّح غيره
رابعاً: حصار أهل البيت وتكميم أفواههم
لقد كان الخليفة الأوّل وكذلك الخليفة الثاني يرجعان في كثير من الأُمور إلى أهل البيت; فأبو حفص كان مفزعه في أُمور الدين الإمام عليّ(عليه السلام)، ولهذا صدر منه مراراً قوله: "لولا عليّ لهلك عمر"، وقوله: "اللّهم أعوذ بك من معضلة ليس لها أبو الحسن"، وهكذا كان دأبهما.
وأعلميّة أهل البيت ـ وعلى رأسهم الإمام عليّ(عليه السلام) ـ من الحقائق التي لا مراء فيها ولا جدال، وقد اعترف بذلك أبو بكر وخليفته أبو حفص. واستمرَّ الحال إلى زمان عثمان حيث استولى بنو أُميَّة على مقاليد الأُمور في الدولة الإسلاميَّة، وتصرَّفوا في كلِّ شيء حتّى هيمنوا على السلطة تماماً، فتغيَّر الحال وحورب أهل البيت، وحوصرت أقوالهم، وسُلب حقّهم في المرجعيّة الدينيّة فضلا عن الخلافة. واستمرَّ الحال هكذا إلى آخر يوم في الدولة العبّاسيّة، فنشأ الناس على ترك أهل البيت. ثمَّ إنَّ الحصار في دولة بني أُميِّة لم يقف على إبعاد أهل البيت النبويّ عن المرجعيّة فحسب، بل تعدّى إلى إبرازهم بنحو يؤدّي إلى نفور الناس منهم، ولهذا الغرض استنّوا سبَّ الإمام عليّ(عليه السلام) أكثر من خمسين عاماً.
وضُرِبَ الحصار على من يرجع إليهم في أُمور دينه، وقُتل من لم يطلق لسانه فيهم بالسباب والشتم، وهُيِّئت الفرص لمن يسبّهم ويجافيهم. وأمر معاوية الناس في بقاع الدولة بإبراز محاسن غيرهم في مقابل ما أبرزه النبيّ(صلى الله عليه وآله) من محاسن لهم، ثمَّ قُتّلوا بعد ذلك شرّ تقتيل، فليس منهم إلاّ مسموم أو مقتول.
والسؤال الذي يُطرَح ببراءة: لماذا حارب الأمويّون طيلة حكمهم هذا علماءَ أهل البيت؟ ولأيِّ شيء قتلوهم؟ ولماذا نسج على منوالهم العبّاسيّون؟
وقد يجيب أحد بأنَّهم نافسوهم في الحكم والسلطة.. ولكن، هل كان أهل البيت يعارضون حكم الأمويّين لو كان قائماً على ما جاء به الوحي وقضى به النبيّ(صلى الله عليه وآله)؟! وهل كان من الوحي سبّ الإمام عليّ أو قتل الإمام الحسين بالصورة الوحشيّة التي عرفها التاريخ؟! أو كان من الوحي إطعامهم السمّ الزعاف؟! وهل كان أبناء الرسول يحبّون السلطة من أجل السلطة والحكم؟ وماذا تضرّر العبّاسيّون من عترة النبيّ(صلى الله عليه وآله)حتّى انتهجوا معهم ما انتهجه الأمويّون؟!
إنّ أهل البيت بعد الضربات الأمويَّة لم تبقَ لهم تلك الخطورة السياسية التي تعتمد على قوّة الجيش والسلاح; فقد انفضّ الناس من حولهم إمَّا خوفاً من القتل والسبي، وإمَّا انجذاباً نحو الأصفر والأبيض من أموال السلطة. وصار أهل البيت تحت المراقبة الأمويَّة في منازلهم وبين أهليهم، أو في المحابس وفي سجون الحكومة العبّاسيّة، وهذا يكفي الحكّام لتوطيد حكمهم. إذن.. لماذا القتل؟! وهل كان لأهل البيت كخطر الجيوش والسلاح لا يزول إلاّ بقتلهم؟! وما ذاك الخطر؟! وهل كان السبيل إلى الصلح والتوافق معهم قد أغلق تماماً؟!
لقد كانت المسألة بين الحكّام من الأمويّين والعبّاسيّين، وبين أهل البيت مسألة الدين والشرع، فالحكّام في نظر أهل البيت قد خالفوا الشرع والنهج
____________
1- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 11 / 44، الباب 23.
وهذا الإمام الحسين يصوّر حقيقة النزاع بين الحكّام وأهل البيت، يقول الطبريّ: "وقام الحسين في كربلاء مخاطباً أصحابه، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس، إنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاّ لِحُرَم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول، كان حقّاً على الله أن يُدخله مُدخله. ألاَ وإنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ من غيري"(1).
فإذا كان النبيّ(صلى الله عليه وآله) قد ربّى أبناء الناس على الدين خير تربية، أتراه تاركاً أبناءه على غير تربية الدين؟! لا، بل لهم الأولويَّة في التربية والنشأة على الوحي، وإلاّ فإنّه يكون كالآمر بالبرِّ والناسي لنفسه.
ولمّا كان هدف أهل البيت إقامة الدين وإجراء الشرع الذي تربّوا عليه وهم أولى بذلك، كان الحكّام في زمانهم يهدفون إلى السلطة فحسب، لأنَّ الذي لا يهدف إلى شيء إلاّ أن يرى الدين قائماً، لا يضيره شيء إن قام الدين بغيره من الناس على الوجه المطلوب.
وهكذا حوصر أهل بيت النبوّة من كلّ صوب، ومُنعوا من الكلام في أيّ أمر في مجال الدين سياسيّاً وعباديّاً. فإن كان هذا حال أهل البيت فمَن مِن أتباعهم تكون له جرأة الكلام والتفوّه بما يرضي العترة النبويّة؟! فلو استهان أمر أهل البيت عند الحكّام فلاَمرُ أتباعهم أشدّ هواناً. ومع ذلك ظهر على سطح الساحة الدينية علماء صار حقّ الفُتيا لهم، وارتضاهم الحكّام، وقصدوا إلى فرض ما أفتوا به على
____________
1- تاريخ الطبري: 4 / 304، حوادث سنة إحدى وستّين.
ولهذا أُبعد أهل البيت، وقُرِّب من خالفهم من العلماء والناس. واستمرَّ الحال هكذا وطارت فتواهم كلّ مطير وانتشرت في البلاد وسار الناس على مذاهبهم، ولم يلتفت أحد إلى بيت النبوّة ومهبط الوحي، فأخذ الناس الدين عن غيرهم. وها نحن نرى الخلاف بين أتباع المذهب الجعفري من شيعة أهل البيت وبين المذاهب السُّنيّة. أفلا يدعو هذا إلى البحث والتحقيق؟!".
ومن منطلق البحث والتحقيق وجد الأخ طارق نفسه أمام حقائق لا سبيل لانكارها فاعلن ولاءه لآل محمد والقول بامامتهم والالتحاق بسفينتهم مطمئن البال، مستقر النفس، مرتاح الضمير، لأنّه شعر بعدها أنّه يمتلك عقيدة راسخة وناتجة عن فهم وبحث ودراية.
موقفه ممن خاصمه بعد الاستبصار:
تعرّض الأخ طارق بعد اعلانه الولاء لأهل البيت لجملة من المضايقات من قبل البعض ممن حوله، لكنه لم يعبأ بها ابداً، بل كان يتعجب من اولئك الذين
"إن الذي ليس له الشجاعة لتقبّل الحقائق والأدلة المقنعة، ولا يتذوقها إلاّ مرّه، لا يجوز له أن يضايق مَن رضي بالحق وقبل الدليل وتذوّق فيه الطلاوة والحلاوة.
غير أنني لم أغلق الباب أمام من يرى خلاف ما رأيت، ويملك من الأدلة ما لم أملك، على أنّه سيظلّ الباب مفتوحاً له، ما دام ينتهج في حواره قوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَـدِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ)(1) وإلاّ فالباب موصَد".
مؤلّفاته:
(1) "دعوة إلى سبيل المؤمنين":
صدر سنة 1418هـ ـ 1998م عن مؤسسة الطبع التابعة للآستانة الرضوية المقدسة.
جاء في تعريف الكتاب على غلافه الأخير: "لغة الحوار الهادىء مظهر حضاري متقدّم... ومزيّة بينة من مزايا هذا الكتاب; إذ مزج فيه مؤلفه بين عمق الفكرة ووضوحها وبين المحاورة الودودة التي تستهدف التعريف والتبصير من خلال المنطق المرضي والبرهان...".
إن هذا الكتاب خطوة عسى أن تكون فاعله في ترصيص كيان الأمة الإسلامية من خلال الكلمة المضئية، للوصول إلى المعنى الاعتقادي والتاريخي المشترك الذي يقف على أرضيته مسلمو العالم.
يتألف الكتاب من تمهيد وخمسة فصول وهي:
التمهيد: التحقيق في أمر العقيدة.
____________
1- النحل: 125.
الفصل الثاني: حديث الاقتداء بأبي بكر وعمر.
الفصل الثالث: خلافة أبي بكر الصديق.
الفصل الرابع: أولو الأمر هم أهل البيت.
الفصل الخامس: الخليفة بعد النبي علي(عليهما السلام).
وقفة مع كتابه: "دعوة إلى سبيل المؤمنين"
يدعو الكاتب في كتابه هذا المسلمين إلى التوحد على هدى الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله)وعدم الانشقاق عنه وسلوك سبيل عترته وأهل بيته(عليهم السلام) المؤمنين حقاً بهدى ابيهم الذي لا ينطق عن الهوى، وهم أوائل السائرين على الصراط المستقيم الذين اصطفاهم الله واختارهم أئمة للناس.
ويتناول في كتابه مسألة اختلاف المسلمين في ولي الأمر بعد الرسول(صلى الله عليه وآله)، فيبحث مقدمة في عدالة الصحابة واختلافهم، ثم يتناول خلافة الخليفتين الأول والثاني فيبحث فيها نصوصاً وتاريخاً فيرد ما استدلوا به عليها من اجماع مزعوم وشورى غاب عنها المشيرون، وترشيح أبي بكر للصلاة من قبل ابنته عائشة قرب وفاة النبي(صلى الله عليه وآله).
ثم يواصل بحثه مستدلا بالآيات القرآنية وتفسيرها من قبل كبار أئمة التفسير، وكذلك بالأحاديث النبوية الشريفة التي اتفق عليها المسلمون لمعرفة ولي الأمر الذي تجب طاعته على المسلمين فيجد ان النصوص الشريفة قرآناً وحديثاً قد وضحت ولي الأمر بما لا يقبل اللبس والابهام وهم أهل البيت(عليهم السلام) الذين لم يتلبسوا بظلم أبداً، والذين لا يقاس بهم أحد كما وضحت النصوص المراد بأهل البيت وان حاول البعض التشويش على ذلك عناداً وضلالا.
ثم استعرض النصوص التي تدل ان الخليفة الذي عيّنه الرسول(صلى الله عليه وآله) هو الإمام علي(عليه السلام) الذي اختاره الله ولياً لكل مؤمن والذي اعترف له بذلك من اغتصب حقه في الخلافة في بعض فلتات السنتهم.
أهمية معرفة ولي الأمر الواجب الطاعة:
يوضّح الكاتب ذلك بالقول:
إنَّ من المسائل التي تفرض علينا التحقيق والبحث حولها باعتبارها من أهم مسائل الدين، هي معرفة وليّ الأمر.
الاعتقاد السائد بين كافّة المسلمين أنَّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) هو خاتم الأنبياء والرسل، أي هو نبيّ لا نبيّ من بعده، وأيّ اعتقاد بخلاف ذلك يستوجب الكفر بلا شكّ. وفرض عدم خاتميّة الرسالة يفرض نبيّاً آخر يأتي بعد محمَّد(صلى الله عليه وآله) لهداية الناس بعد انقضاء فترة الإسلام، ولمّا لم يكن كذلك.. فُهِمَ الإسلام على ضوء ختم الرسالة بأنَّه دين كلّ زمان ومكان، وهذا منطق بلا شكّ يتّفق وختم الرسالة، وعلى هذا تصافق وتوحّد اعتقاد المسلمين باعتباره أمراً قرآنياً مسلَّماً (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَد مِّن رِّجَالِكُمْ وَ لَـكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَىْء عَلِيماً)(1)، وعلى هذا فإنَّنا نستخلص من هذا الاعتقاد المسائل التالية:
1 ـ ليس هناك نبيّ يأتي بعد محمَّد(صلى الله عليه وآله)، فهو خاتم وآخر الأنبياء والرسل.
2 ـ إنَّ الإسلام خاتم الأديان، وهو قد جاء إذاً لكافة الناس إلى يوم القيامة.
3 ـ ولكي يفي الإسلام بهذه العموميّة لكلّ البشر، وحتّى يفي بمتطلّبات عموم الناس على اختلافهم وتنوّعهم زماناً ومكاناً، لابدَّ أن يكون على درجة من القوّة والكمال حتّى ينهض بالناس دينيّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً وخلقيّاً واقتصاديّاً، ولهذا يقول تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِْسْلَـمَ دِيناً)(2) والله لا يرضى بما هو ناقص غير مكتمل، كما هو واضح.
____________
1- الأحزاب: 40.
2- المائدة: 3.